-
الاضطرابات النفسية لدى الأطفال
عنوان الموضوع : الاضطرابات النفسية لدى الأطفال
مقدم من طرف منتديات المرأة العربية
1-اضطرابات ضعف الانتباه فرط الحركة :
طفل في السابعة من عمره يشكو منه مدرسوه أنه لا ينصت للشرح ولا يستوعب جيدًا على الرغم من أنه يبدو ذكيًا وهو في نفس الوقت لا يكفُّ عن الحركة أبدًا فهو ينتقل من مكان إلى مكان في الفصل ويقفز فوق الكراسي وأحيانًا يقفز من الشباك إلى الصالة وكثيرًا ما يكسِّر الأشياء داخل الفصل ويخطف الأدوات المدرسية من زملائه ويؤدى ذلك إلى كثرة الشجار معهم والى طرده من الفصل وأحيانا من المدرسة.
واستدعى الأخصائي الاجتماعي ولي أمره فحضرت الأم وذكرت أنها تعانى من نفس المشكلات معه في المنزل فهو لا يكفُّ عن الحركة إلا "عند النوم " وكأن موتورًا يحركه بلا توقف ولا يترك شيئًا في مكانه ولا يستطيع التركيز في عملٍ واحد لفترة طويلة بل ينتقل من شيءٍ لآخر دون أن يتمَّ أي منهم وهو لذلك لا يستطيع أن يذاكر دروسه أو يكتب واجباته إلا بصعوبة شديدة وبمتابعة مستمرة ومضنية من الأم .
هذا الطفل هو مثال لاضطراب يسمى: "ضعف الانتباه فرط الحركة " وهو يحدث في 2-20% من أطفال المدارس ويكون حدوثه أكثر في الطفل الأول ربما لأنه يعانى أثناء الولادة من ضغط رأسه في قناة الولادة الضيقة حيث لم يسبقه أحد في المرور من هذه القناة من قبل، وربما لأن الطفل الأول يحظى بتدليل أكثر وتترك له الفرصة ليفعل ما يريد حتى ولو كان مزعجاً وهذا لا يمنع أن يحدث هذا الاضطراب في غير الطفل الأول.
ولو راجعنا تاريخ الأبوين فربما نجد حالات مشابهة لدى أحدهما أثناء فترة الطفولة، أو أن يكون لديه اضطراب في سلوكه الاجتماعي، أو يكون متعاطيًا للكحول أو أحد المخدرات الأخرى، أو تكون شخصيته ذات سمات هستيرية وهناك أكثر من سبب يمكن أن يؤدى إلى هذا الاضطراب فمثلاً هناك العوامل الوراثية كما ذكرنا من قبل، أو عطب بالمخ حدث أثناء فترة الحمل أو الولادة أو ما بعد الولادة، أو اضطراب في بعض الناقلات الكيميائية العصبية داخل المخ أو عدم نضج لبعض مراكز التحكم في المخ، وربما لا يكون هناك أحد هذه العوامل العضوية ويرجع الاضطراب إلى عوامل نفسية اجتماعية كأن ينشا الطفل في بيئة ليس بها حدود أو ضوابط أو يدلل أكثر من اللازم فيفعل ما يشاء وقتما يشاء وبأي طريقة كانت.
وتعالج هذه الحالات باستخدام بعض الأدوية مثل مشتقات الأمفيتامين Amphetamine (الريتالين Ritalin) أو مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (التوفرانيل) أو عقار الكاربامازيبين (تيجريتول)، بالإضافة إلى العلاج السلوكي وهو أن توضع ضوابط للطفل في المنزل والمدرسة ويتدرب على الالتزام بها وفى حالة الفشل فيمكن حرمانه من الأشياء التي يرغبها إذا لزم الأمر.
2- اضطراب العناد الشارد :
طفل في العاشرة من عمره أحضرته أمه للعيادة وهى تشكو منه بمرارة لأنه كثير الجدال في كل شيء، ومستفز بشكل دائم ولديه رغبة في مخالفة كل النصائح أو التعليمات التي يتلقاها من الأب أو الأم فهو يفعل عكس ما يريدون فإذا طلبوا منه الذهاب شرقاً واتجه فوراً ناحية الغرب، ودائما في حالة تحدى وخروج عن الطاعة وعن الخط العام للأسرة .
هذا مثال لحالة العناد الشارد وهى توجد في 16-22% من ط§ظ„ط£ط·ظپط§ظ„ في سن المراهقة.
وإذا حاولنا تقصى الأسباب فربما نجد بعض أو كل الأسباب التالية: -
1- ميل الأبوين للتحكم والسيطرة، فيشعر الطفل أن الأبوين يقهرانه ويلغيان إراداته فيحاول هو في المقابل ـ لنفسه و لهما ـ إثبات أن له إرادة مستقلة وأن له عقل مستقل.
2- الأم المكتئبة المرهقة والتي لا تجد وقتا ولا طاقة للتفاهم والتحاور مع الأبناء فتميل إلى إعطاء الأوامر بلا نقاش ( لأنها غير قادرة عليه ) فيحدث العصيان.
3- الأب ذو العدوان السلبي (الكياد) الذي يميل إلى أن يستفز من أمامه بشكل هادئ وعنيد، والطفل العنيد غالبًا ما يكون له أب عنيد وأم عنيدة .
4-أو يكون الطفل غير مرغوب فيه كأن يأتي بعد أطفال كثيرين قبله، أو تأتي بنت بعد بنات قبلها.. وهكذا ، فيشعر الطفل أنه منبوذ أو على الأقل غير مستحب فيحاول إثبات وجوده بالعناد والمخالفة.
5- أو أن الطفل يشعر بالعجز والدونية ونقص اعتبار الذات .
6- اضطراب المزاج .
7- وكثيرًا ما تساهم الأسرة في ازدياد سلوك العناد وذلك بتدعيم هذا السلوك إما بعنادٍ مضاد أو باستجابة لما يريد تجنبًا لهذا العناد .
8- ويمكن أن يكون العناد دفاعًا ضد الاعتمادية الزائدة على الأم وخاصة لدى الطفل المدلل أو الوحيد، حيث يريد من خلال عناده أن يقول: أنا هنا أنا كيان مستقل أنا رجل .
وإذا تدبرنا الأسباب فان العلاج يكون بتلافيها ولكن تبقى بعض الحالات التي تحتاج لعلاج نفسي فردي مع أحد المتخصصين حيث يستكشف سبب العناد لدى الطفل ويحاول أن يزيد بصيرته بهذا السلوك الضار ويوضح له بدائل صحية تعود عليه بالنفع ويشجعه على تبنى تلك البدائل من خلال برنامج للعلاج السلوكي.
وأحيانا ( بل كثيرا) ما يتم التوجه بالعلاج نحو الأبوين لأن عناد الطفل يكون انعكاسًا لعنادهما واضطرابهما.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
3- التبول اللاإرادي ( البوال) :
ابنتي في الثانية عشرة من عمرها تتبول كل ليلة في فراشها وقد حاولنا معها بكل الطرق ولكنها لا تتوقف عن ذلك، بل إنها تتبول أحيانًا إذا نامت بالنهار.. وقد أدى هذا إلى انطوائها وخجلها … وكثيرًا ما تجلس حزينة وحدها في غرفتها … وأحيانًا تحدث مشاجرات بينها وبين إخوانها لأنهم يعيرونها بتبولها في الفراش.. وهى ترفض أن تحضر معنا لزيارة الأقارب أو المبيت خارج المنزل خشية أن ينكشف أمرها أمام الناس.
هذه الحالة نتيجة لاضطراب يسمى البوال وهى حالة نراها بكثرة في العيادة النفسية حيث تبلغ نسبتها 10-15% من الأطفال والمراهقين، وهى تمثل اضطراباً في فسيولوجيا التبول حيث أنه في الحالات الطبيعية عندما تمتلئ المثانة بالبول ترسل إشارات عصبية إلى مراكز التحكم في المخ فإذا كانت الظروف مناسبة للتبول فإن هذه المراكز تعطي محتوياتها عن طريق الحبل الشوكي فتفرغ المثانة محتوياتها من البول.
ولهذه الحالة أسباب بعضها معروف وبعضها الآخر ما يزال مجهولاً.
ونذكر منها ما يلي:
1- الوراثة: حيث وجدت حالات مشابهة في الأسرة (أحد الوالدين أو أحد الأقارب) .
2- توتر المثانة : بحيث أنها لا تستطيع الاحتفاظ بأي كمية من البول بل تقذفها مباشرة إلى الخارج (مثانة عصبية).
3- نقص نضج الجهاز العصبي وخاصة مراكز التحكم في البول.
4- النكوص: حيث يميل الطفل إلى العودة إلى مراحل مبكرة ليحصل على ما كان يحصل عليه من رعاية واهتمام ،
وهذا يفسر حدوث هذه الحالة في طفل بلغ ثامنة من عمره مثلاً ولم يكن يتبول ولكنه بدأ يتبول بعد ولادة طفل صغير في الأسرة فكأنه يقول: اعطوني اهتماماً فأنا مازلت" عيل " أتبول على نفسي مثله.
5- العداء للأم أو للأسرة وبهذا يصبح التبول رمزاً للعدوان عليهم.
6- الاكتئاب.
7- زيادة عمق النوم، حيث لوحظ أن الأطفال الذين يتبولون أثناء النوم لا يسهل إيقاظهم .
وهذه الحالة تكمن خطورتها في الآثار النفسية المترتبة عليها حيث يصاب الطفل بحالة من الخجل والانطواء والشعور بالدونية وتزداد هذه المشاعر كلما كبر سنه. وعلى الرغم من أن 75% من الحالات تشفى تلقائيا في سن المراهقة وأن 95 % تشفى في العشرينات من عمرها إلا أن العلاج المبكر يجنب الشخص أثارا سلبية كثيرة.
والعلاج المبكر يبدأ بتدريب المثانة أثناء النهار على استيعاب البول لزيادة سعتها وذلك بتأخير التبول لمدة ساعة أو أكثر كلما شعر الطفل بالرغبة في التبول.
وهناك بعض العقاقير التي تستخدم وتؤدى اللي نتائج جيدة ومنها مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (مثل التوفرانيل) وتستخدم جرعات بسيطة في البداية وتزداد تدريجيا حتى يتوقف التبول أثناء النوم ويستمر الطفل على هذه الجرعة لمدة 6 شهور ثم نعطيه راحة من العلاج لمدة أسبوع، فإذا عاد إلى التبول مرة أخرى نستمر 6 شهور أخرى وهكذا.
وهناك عقار يسمى المينيرين ثبتت فاعليته في كثير من الحالات ويتميز بأنه سهل التعاطي وأعراضه الجانبية أقل وتوجد وسائل للعلاج السلوكي وهى عبارة عن : فرش من نوع خاص يوضع على السرير وقد زود بجرس، فإذا تبول الطفل فان الماء يغلق دائرة كهربية فيحدث الجرس صوتًا فيستيقظ الطفل، وبهذا يستيقظ بامتلاء المثانة، وهذه الطريقة مأخوذة من طريقة كان يستعملها بعض الأفارقة في المجتمعات البدائية حيث كانوا يربطون ضفدعة في العضو الذكرى للطفل، فإذا تبول الطفل أثناء النوم فان الضفدعة تحدث صوتا يوقظ الطفل.
ويجب مع كل هذه الوسائل أن يكون هناك علاجاً نفسياً للطفل من آثار هذه الحالة.
وهناك بعض التعليمات المفيدة وهى أن الطفل لا يشرب سوائل بعد المغرب وإذا شعر بالعطش يكتفي بشرب قليل من الماء، وأن يتبول قبل الذهاب للفراش مباشرة، وأن يوقظه أحد أفراد الأسرة مرة أو مرتين أثناء الليل للتبول.
4- التبرز اللاإرادي :
وهي حالة أقل شيوعًا من التبول اللاإرادي وهى تشترك في أسبابها وعلاجها مع ما ذكرنا في حالة التبول اللاإرادي مع بعض الفروق البسيطة.
واقرأ أيضًا على مجانين:
اضطراب البوال / العناد والعدوان السلبي / طفلي مفرط الحركة قليل الانتباه ! / نقص الانتباه المفرط الحركة !
اضطراب العناد الشارد /التبول اللاإرادي : أحيانا وراثة / التبول اللا إرادي في الأطفال مشاركة مستشار
الصحة النفسية للطفل (1) / مفهوم اللغة في حياة الطفل / الكلمة الافتتاحية / أصل حكايتنا نحن البشر / إغواء آدم وذريته
__________________________________________________ __________
5- القلق :
إن القلق يصاحب الإنسان من مولده وحتى وفاته، وربما يكون هذا مصداقًا للآية الكريمة " لقد خلقنا الإنسان في كبد "(سورة البلد آية رقم 4) فهو يكابد آلام الولادة ويكابد مشكلات الرضاعة والتربية والاتصال والانفصال والخوف من فقد الأم ( مصدر الحب والرعاية والحنان ) أو فقد الأب ( مصدر الإنفاق والحماية )، وفى كل مرحلة توجد مصادر عديدة للقلق ، ومع هذا فإن القلق ليس مرضًا في كل الحالات، بل هو يؤدى وظيفة هامة لبقاء الإنسان إذا ظل في الحدود المقبولة، لأنه يدفع الإنسان للابتعاد عن الأشياء التي تهدد وجوده أو سلامته ولكن إذا زاد القلق عن هذه الحدود فهو يؤثر تأثيرًا سلبيا على الطفل كما سنرى.
والقلق عند الطفل يمكن أن يعبر عنه في صورة أعراض نفسية كالخوف المفرط من أشياء لا تستحق ، كالخوف من الأشخاص الغرباء والخوف من الظلام والخوف من الحيوانات... الخ ، أو العصبية الزائدة والصراخ أو البكاء المستمر والتعلق بالأم طول الوقت ، وأحيانا يظهر في صورة أعراض جسمانية كفقد الشهية للطعام وفقد الوزن واضطرابات البطن وكثرة التعرض للالتهابات، والقيء المتكرر، وعدم الاستقرار الحركي.. الخ .
ويمكن استعراض أنواع القلق في فترة طويلة كالآتي:
1- قلق الانفصال:
حيث يصاب الطفل بخوف شديد عند أي محاولة لإبعاده عن أمه ويظل ملتصقا بها طول الوقت أينما ذهبت، وتظهر المشكلة أكثر عندما تحاول الأسرة إلحاق الطفل بالحضانة أو المدرسة حيث يرفض الطفل رفضاً تاماً الذهاب إلى أي مكان يبتعد فيه عن أمه، ويصاب بحاله من الهلع إذا تركته الأم في أي مكان وذهبت بعيداً.
وهذه الحالة تعالج باستخدام مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل (الاميبرامين) مع بعض مضادات القلق بالإضافة إلى العلاج النفسي وذلك بأن تذهب الأم مع الطفل في اليوم الأول إلى المدرسة وتجلس معه نصف ساعة ثم تعود به، وفى اليوم التالي تجلس فترة أطول ثم تعود به، وفى اليوم التالي تجلس فترة أطول ثم تعود به، وهكذا لمدة أسبوع. وفى الأسبوع الثاني يذهب الأب مع الطفل ويكرر ما فعلته الأم، ثم يبدأ الأب بالانسحاب التدريجي في الوقت الذي يكون الطفل فيه قد ارتبط بالمكان والأطفال.
2- التجنب :
في هذه الحالة نجد الطفل خائفًا ومتجنبا كل شيء ، يتجنب أي موقف جديد أو علاقة جديدة مع أحد ويتجنب أي محاولة جديدة للتعرف على الأشياء من حوله ويظل يدور في محيطه المألوف الضيق.
3- القلق المفرط :
مثال ذلك الطفل الذي يتوتر ويضطرب لأي تغيير في حياته، فهو يقلق مع دخول المدراس قلقًا شديداً، ويقلق إذا حضر ضيوف غرباء إلى البيت، ويقلق إذا انتقلت الأسرة لمنزل جديد، ويقلق بشدة إذا ولد للأسرة طفل جديد.. وهكذا نجده يقلق لأي حدث عادى في الحياة بشكل يتجاوز حدود القلق الطبيعي فهو باختصار يحمل هم كل شيء ويجده صعباً مخيفاً.
4- الرهاب :
وهو حالة من الهلع عند رؤية شيء معين أو المرور بموقف معين فقد تحدث هذه الحالة مثلاً عندما يرى الطفل قطة أو فأرًا أو ثعبانًا أو كلبًا أو أحد الأشخاص أو أن يكون في مكان مرتفع أو مكان واسع مفتوح أو مكان مغلق مزدحم وفي هذه الحالات يكون الطفل في حالة فزع شديد ووجه مصفر وعرقه غزير ونبضه سريع ويداه باردتان مرتعشتان، ويحاول الاحتماء بأقرب شخص إليه.
5- الوسواس :
ويأخذ شكل أفكار معينة تتسلط على الطفل ويظل مشغولاً بها طول الوقت ولا يستطيع التخلص منها، أو يكون في صورة فعل قهري كأن يكرر غسل يديه مرات عديدة ويقضي في دورة المياه أوقاتًا طويلة ليتأكد أنه تطهر من نجاسته، أو يعيد الوضوء مرات عديدة أو يعيد الصلاة أو يصر على غسل ملابسه إذا مرت بجوار قطة... الخ .
وهذه الأنواع المختلفة من القلق يمكن علاجها بمضادات القلق ومضادات الاكتئاب والعلاج النفسي الفردي أو السلوكي أو العائلي أو كلاهما معاً وعلى الأسرة أن تراجع طريقة تربيتها لأطفالها فتجعل جو البيت آمنا هادئاً ولا تبالغ في الخوف من الأحداث أو الأشياء وتعود الطفل على الاستقلال والمغامرة لاكتشاف البيئة من حوله، وعلى الأم ألا تبالغ في الخوف من النجاسة أو القذارة لأن الأصل في الأشياء الطهارة، فقد وجد أن نسبة كبيرة من حالات الوسواس القهري لدى الأبناء يكون سببها النظام الصارم للام (أو الأب) الذي يتشكك في النظافة والطهارة والنظام ويبالغ في التدقيق في كل شيء.
__________________________________________________ __________
6- اضطراب السلوك :
يعرف اضطراب السلوك بأنه هو النمط الثابت والمتكرر من السلوك ـ العدواني أو غير العدواني ـ الذي تنتهك فيه حقوق الآخرين أو قيم المجتمع الأساسية.
واضطرب السلوك يمكن أن يظهر في أحد الأشكال التالية:
1- العدوان:
طفل كثير الشجار والعراك مع إخوانه وزملائه في المدرسة، يميل دائمًا إلى استخدام الألفاظ النابية في تعامله مع الآخرين ويميل أيضًا لاستخدامه يديه ورجليه، يحطم الأشياء في البيت والمدرسة، لا يكتفي بالاعتداء على الحيوانات فيخنق القطط والعصافير والكلاب وأحيانا يعذبها حتى الموت وهو يستمتع بذلك ولا يكف عن إثارة المشكلات أينما ذهب.
ولهذا السلوك العدواني أسباب يمكن أن نوجزها فيما يلي :
- محاولة الطفل لجذب انتباه الآخرين إليه خاصة إذا كان يحس أنه مهمل في البيت أو المدرسة .
- حماية نفسه بهذا السلوك العدواني خصوصًا إذا كان يعيش في بيئة يسود فيها العنف والعدوان والسيطرة للأقوى
- رؤية مشاهد العنف في الأفلام والمسلسلات ، ويعتبر هذا من أهم الأسباب التي تساعد على ظهور السلوك العدواني ، فالطفل حين يشاهد أفلام العنف فانه يقلد السلوكيات العنيفة التي رآها وأعجب بها، وفى نفس الوقت تقل حساسيته لعواقب السلوك العدواني فهو يرى كل يوم بطل الفيلم يقتل ويدمر ولا يحدث له شيء بل يظهر في صورة براقة وأحيانا يأخذ صورة البطل الذي يقتل ويدمر ليساعد الناس، والطفل يتعلم من هذه الأفلام والمسلسلات أنماطًا جديدة للسلوك العدواني لم يكن يعرفها ومن الأمثلة الواضحة على هذا التأثير مسلسلي هرقليز وزينا وهما مسلسلين عالميين عُرضا في أغلب تليفزيونات العالم، وأثناء عرضهما كنا نجد الأطفال في المنازل يجلسون في صمت شديد يتابعون أحداث العنف المتتالية بشغف شديد، وما أن ينتهي المسلسل حتى يندفع الأطفال مباشرة ليقفزوا في الهواء وليضربوا أقرانهم وليحطموا الأشياء في المنزل أو في الشارع.
- أو يكون السلوك العدواني تعبيرًا عن الغيرة خاصة بعد مولد طفل جديد، أو غيرة الطفل من بقية أخواته أو زملائه إذا كانوا متفوقين عليه في أحد الجوانب وهو يعجز عن اللحاق بهم.
- ويعتبر الإحباط من أقوى الدوافع للعنف والسلوك العدواني، فحين يشعر الطفل بأنه لن يستطيع تحقيق أهدافه بشكل طبيعي فإن طاقته تتجه إلى العدوان لتحطيم الموانع التي تحول دون ذلك.
- والطفل الذي يتعرض للعقاب الجسماني من أحد أبويه أو كليهما أو المدرسين في المدرسة فإنه يميل إلى أن يكون عدوانياً، لأنه لا يستطيع أن يرد عدوان الأب أو الأم أو المدرس فيتجه إلى إخوته وزملائه.
- أو يكون السلوك العدواني نتيجة تهاون من الوالدين فيجد الطفل الطريق مفتوح أمامه لممارسة عدوانه دون حساب.
2- السرقة:
أحضرت أم ابنتها البالغة من العمر 12 سنة إلى العيادة النفسية وهى تشكو من أن ابنتها تسرق كل ما تقع عليه عينيها من أشياء في المنزل أو المدرسة، وقد سبب هذا مشكلات كثيرة للبنت وللأسرة وخاصة أن الأسرة تتكون من أب في وظيفة محترمة ومتدين والأم كذلك ، وقد فشلت كل محاولات الترهيب والترغيب مع هذه البنت. وفعل السرقة يختلف من حاله إلى حالة ، وكل حالة تعالج بشكل مختلف طبقا لنوعها وظروفها وفيما يلي نذكر بعض أسباب السرقة لدى الأطفال:
- نقص الإحساس بحقوق الملكية، أي أن الطفل يكون غير مدرك للحدود التي تفصل بين ما يملكه هو وما يملكه الآخرين فيظن مثلا أن كل ما في المنزل يعتبر ملكه، وهذا يحدث في الأطفال الصغار أو ذوى الذكاء المحدود، وهذه الحالة تزول بمجرد أن يتعلم الطفل وينضج.
- استعادة الأم المفقودة، بمعنى أن الطفل يشعر أنه قد فقد اهتمام أمه ورعايتها له وذلك بسبب ولادة طفل جديد، لذلك فهو يأخذ الأشياء التي هي رمز لحب الأم الذي يحاول استعادته.
- أو تكون السرقة مجرد فعل عدواني يريد به الطفل أن يغيظ الأب أو الأم أو الأخوات.
- أو تكون رغبة شديدة في الامتلاك.
- وأحيانا تكون السرقة محاولة لرد اعتبارات الذات، فمثلاً البنت التي تشعر أنها ليست جميلة وسط زميلاتها تميل إلى سرقة الأشياء من حقائبهن في المدرسة.
- وربما يسرق الطفل لمجرد الإثارة حيث يتعلم أن فعل السرقة يثير ردود أفعال لدى الأب والأم ويكسر الملل داخل الأسرة.
- وأحيانا تكون السرقة مرضًا يسمى هوس السرقة وفى هذه الحالة لا يكون سببًا واضحًا للسرقة والشخص يميل لأن يسرق أشياء لا يحتاجها، وهو يشعر بالتوتر إذا وجد شيئًا أمامه ولا يزول هذا التوتر إلا بسرقة هذا الشيء.
- أو تكون السرقة نتيجة نقص الذكاء حيث لا يعرف المتخلف عقليًا أخذ أشياء لا تخصه.
- ويتم عرض حالات السرقة على الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي لمعرفة دوافعها وأنواعها وتحديد خطة العلاج الطبية والنفسية والعائلية.
3- الكذب:
وهو أنواع كثيرة نذكر منها ما يلي :
- الكذب الخيالي: ويحدث مع الأطفال صغار السن الذين لا يستطيعون التفرقة بين الواقع والخيال فيختلط لديهم هذا بذاك.
-كذب المبالغة: وهو أن يضيف الطفل إلى الأحداث الحقيقة أبعادا كثيرة من عنده، وغالبا يكتسب الطفل هذه الصفة من أحد أبويه، كأن يكون أبوه يميل إلى المبالغة في وصف الأشياء.
- كذب المحاكاة: حيث يقلد الطفل أحد أفراد الأسرة الذي اعتاد الكذب أمام الطفل.
- الكذب الاجتماعي: وهو يحدث حين يحاول الطفل أن يخرج من مأزق اجتماعي بالكذب.
- الكذب للدفاع عن النفس: حيث يعتقد الطفل أنه لن يحصل على حقه أو يدفع الأذى عن نفسه إلا بالكذب.
- الكذب لجذب الانتباه: فالطفل يريد أن يشد انتباه من حوله بتضخيم الحقيقة أو إضافة أشياء لم تحدث إليها أو أحداث خيالية مثيرة.
- الكذب الكيدي: والذي يقصد به الطفل أن يغيظ الآخرين.
- الكذب التعويضي: وفى هذه الحالة يشعر الطفل بالضعف أو النقص في جانب ما إن يكون ضعيف البنية مثلاً فيحكي عن بطولات ومغامرات قام بها وهى في الواقع لم تحدث.
- الكذب المرضى: وفى هذه الحالة يعتاد الطفل الكذب في كل المواقف حتى ولو لم يعد الكذب عليه بأي نفع.
__________________________________________________ __________
ولاضطراب السلوك عمومًا أسباب كثيرة نذكر منها:
أ- عوامل بيولوجية: كالوراثة
مثلاً بأن يرث الطفل اضطراب السلوك من أحد أبويه، أو شذوذ الجينات (xyy,xxy ) أو اضطراب وظيفة المخ .
ب- عوامل اجتماعية:
وهذه العوامل إما أن تكون في الأسرة أو في المجتمع، ففي الأسرة يمكن أن نجد حالات التفكك الأسرى أو العلاقات المضطربة بين الأب والأم والأبناء، أو يكون المجتمع الذي يعيش فيه الطفل يدفع نحو العنف والسرقة والكذب وباقي السلوكيات المضطربة .
ج- عوامل نفسية: مثل
- اضطراب علاقة الطفل بالأم كأن تكون الأم قاسية أو غير قادرة على إشباع حاجات الطفل البيولوجية والنفسية.
- نقص مستوى الذكاء وما يتبعه من عدم قدرة الطفل على التكيف مع المجتمع من حوله وإحساسه الدائم بالدونية.
- سيطرة شخصية الأم أو غياب الأب: فكما يقولون في الحكمة: " الرجل لا يربيه إلا رجل " فلكي ينمو الطفل سويًا لابد وأن يكون أمامه نموذجاً للرجل السوي ممثلاً في أبيه ، لذلك فالأطفال الذين يعانون من غياب آبائهم نتيجة للسفر أو العمل لمدة طويلة ربما يكونون عرضه لاضطرابات السلوك أكثر من غيرهم .
- الشعور بالإحباط : فالطفل الذي يشعر أنه فاشل وأنه لا يستطيع تحقيق آماله وأحلامه نظرًا لصعوبات كثيرة في نفسه ( كضعف إمكانياته وملكاته الجسمانية أو النفسية ) أو في الأسرة التي لا تسمح له بالتعبير عن نفسه فإنه يلجأ إلى السلوكيات العدوانية كتعويض وكنوع من إثبات الذات ومعاقبة الآخرين الذين أحبطوه.
__________________________________________________ __________
- وإذا سألنا أنفسنا: ما هو العلاج لحالات اضطراب السلوك ؟ فيمكن أن نلخص الإجابة في النقاط التالية:
1- علاج وقائي :
وذلك بتجنب كل العوامل البيولوجية والاجتماعية والنفسية سالفة الذكر ، وأن نحرص على أن يكون جو الأسرة متسمًا بالأمان والطمأنينة والسماح والحب وأن يكون دور الأب ودور الأم واضحًا ، وأن نعامل كل طفل حسب إمكانياته وقدراته ولا نقارنه ببقية أقرانه فيشعر بالعجز والدونية وأن نعطيه الفرصة كاملة للتعبير عن نفسه وعن قدراته دون قهر أو إلغاء لإرادته واختياره ، فالتربية الصحيحة ليست إلغاء لإرادة الطفل أو اختياره وإنما هي تدعيم للخيارات الصحيحة ومحاولة توعية وتنبيه تجاه الخيارات الخاطئة فالإنسان ميزه الله تعالى بالإرادة والاختيار ولابد أن يتعلم أن يكون مريدًا ومختاراً حتى في مراحل الطفولة المبكرة لأننا لا نتصور انتزاع ذلك منه حتى يكبر فلو فعلنا ذلك فإن الطفل إما أن يدخل في عناد معنا ليدرب سلوكه أو يلغى ارادته واختياره لصالحنا ولا يستطيع استعادتهما حتى بعد أن يكبر وبهذا يصير اعتماديا عديم الإرادة ،
ولنا في قصة سيدنا نوح مع ابنه عبرة بالغة فقد نادى نوح ابنه قائلا : ( يا بني اركب معنا ) فيرفض الابن هذا النداء ويقرر أنه سيأوي لجبل يعصمه من الماء فيوضح له الأب المشفق عليه والعالم أن لا عاصم اليوم من أمر الله فيصر الابن على هذا الخيار فيسلم الأب أمره إلى الله ولا يحاول أن يدفعه للركوب في السفينة قهراً لأنه لو فعل يكون قد ألغى إرادة ابنه واختياره وهذا ما لم يقدره الله تعالى للبشر مهما كانت خيارتهم فللبشر حدود يقفون عندها والله هو القادر على كل شيء (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) (القصص 56) وكثير من الآباء أو الأمهات يدخلون في صراع مع الأبناء بهدف تغيير إراداتهم أو خيارتهم وهم يعتقدون أنهم لابد وأن يفعلوا ذلك طوال الوقت ليكونوا مطبقين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) (متفق عليه) فهم يعتقدون أنهم مكلفين بهداية أبنائهم وهم فعلا مكلفين بذلك ولكن هناك كما يقول الفقهاء نوعين من الهداية
النوع الأول : أي الدعوة والنصح والإرشاد والتعليم .. الخ . وهذه يستطيع البشر أن يقومون بها وقد بدا بها الأنبياء ويكمل مسيرتهم العلماء والمدرسين والآباء.والنوع الثاني وهو هداية الفعل وهذه لا يملكها إلا الله الذي أعطى للإنسان حرية الاختيار وحرية الفعل ثم يحاسبه بعد ذلك ، ليس معنى هذا أننا ندعو الآباء والأمهات إلى أن يتركوا الحبل على الغارب لأبنائهم ولكننا ندعو إلى الحزم الطيب وإلى المعاملة الحسنة والقدوة الحسنة التي يحبها الطفل عن اختيار منه وليس عن قهر يعانده ومن أهم أساليب العلاج الوقائي : أن يكون للأسرة مرجعية واضحة لما هو صحيح وخطأ ولما هو حلال أو حرام وأن يكون مبدأ الصواب والعقاب دائمًا ( دونما إفراط أو تفريط) فمنها يتعلم القانون الأخلاقي ويصبح هذا القانون جزء من ذاته يحكم سلوكه داخله فلا يحتاج طوال الوقت لتعديل سلوكه من الخارج ولكن يحدث استنتاج للقانون الديني أو الأخلاقي في شخصية الطفل فلابد أن يحب الطفل هذا القانون من خلال حبه للمربي فإذا لم يستطع الطفل أن يحب المربي (الأب أو الأم أو المدرسة) فإنه يرفض هذا القانون ويعتبره شيئًا خارجيًا مفروضًا عليه فيقاومه وينتهكه كلما استطاع ذلك .
2- علاج الحالة المرضية
علاج نفسي واجتماعي :
وهذا العلاج يمكن أن يأخذ مساراً تعليميا حيث يتم إعادة تعليم الطفل والأسرة الأساليب الصحية للتعامل، أو أن يأخذ مساراً سلوكيا بأن يوضع الطفل في وسط علاجي يدعم فيه الجوانب الايجابية من خلال نظام التشجيع المعنوي والمكافآت ويضعف الجوانب السلبية من خلال نظام الحرمان من بعض المزايا أو التعرض لبعض العقوبات العلاجية أو أن يأخذ مسارًا أسريًا حيث تدخل الأسرة بأكملها في العلاج على اعتبار أن اضطراب سلوك الطفل يعكس اضطرابًا في الأسرة ككل وأنه لا يمكن إصلاح اضطراب سلوك الطفل إلا بإصلاح المصدر الأساسي لاضطرابه وهو الأسرة ويتم هذا من خلال جلسات متعددة للعلاج الأسري يقوم بها معالج متخصص في العلاج الأسرى . .
علاج بالعقاقير:
فقد ثبت أن لبعض العقاقير تأثير على سلوكيات المضطربة مثل عقار الكاربامازيبين (التيجريتول)
أو اللثيوم ( البريانيل) أو الهالوبيريدول (السافينيز) أو مضادات الاكتئاب
قواعد الصحة النفسية للطفل دكتور / محمد المهدي استشاري الطب النفسي
إشكالية العلاقة بين الآباء والأبناء :
من خلال الجلسات النفسية الفردية وجلسات العلاج النفسي الجمعي ينكشف الستار عن اضطراب العلاقة بين الأبناء والآباء , ويكون هذا الاضطراب من أهم العوامل المهيأة والمرسبة للإضطرابات النفسية لدى الطرفين . وفى أغلب الحالات تضطرب هذه العلاقة دون قصد فالوالدين بدافع فطرى يريدان السعادة والنجاح لأبنائهما ولكنهما أحيانا يفقدان الطريق الصحيح عن غير قصد فيتورطان في الإفراط أو التفريط وتكون النتيجة في الحالتين اضطرابا نفسيا في الطفل الذي أحباه ودفعا حياتهما ثمنا ليكون سعيدا .
ومما يزيد الأمر صعوبة في بيئتنا الشرقية أن اضطراب العلاقة بين الآباء والأبناء يظل تحت غطاء ساتر طوال الوقت ولا ينكشف إلا في ظروف شديدة الخصوصية كالعلاج النفسي الفردي أو الجمعي أو العائلي , أما في غير هذه الظروف فإن الأبناء - غالبا - لا يجرؤن على الاقتراب من هذه المنطقة الحساسة وهم في حالة الوعي العادي , أما الآباء فإن لديهم اعتقاد بأنهم قدموا أفضل ما عندهم لأطفالهم ولكن تمرد الأطفال وعصيانهم للأوامر هو الذي جعلهم في حالة اضطراب .
مفهوم الصحة النفسية :
تراكمت في السنوات الأخيرة معلومات مفيدة حول أفضل الوسائل للوصول إلى الصحة النفسية للطفل وعلاج الإضطرابات النفسية لديه , وقد حاولنا - بعون من الله - أن ننتقى من المعلومات المتوافرة ما يتمشى مع ثقافتنا ويساعدنا في تربية أبنائنا وبناتنا بشكل صحيح . ولا يعتقد أحد أن عملية التربية عملية سهلة , وإنما هي دائما تحتاج إلى جهد وتواجه مشكلات وصعوبات , ونحن هنا نحاول أن يكون الجهد المبذول على الطريق الصحيح . ونحن لن ندخل في عرض نظريات تربوية ترهق القارئ وربما لا تعنيه كثيراً وإنما سنتكلم بشكل عملي من خلال الرسائل التي تصلنا كل يوم أثناء الجلسات النفسية العميقة سواء كانت فردية أو جماعية مع الأطفال والكبار . وفي هذا الصدد نواجه سؤالاً بالغ الأهمية ، ما هي الصحة النفسية؟
وكيف يصبح الإنسان صحيحاً نفسياً ؟
قد تكون الإجابة ببساطة هي أن الإنسان الخالي من الأمراض النفسية هو الإنسان الصحيح نفسياً ، لكن هذا التعريف للصحة النفسية مختزل جداً ، ولا يؤدي الغرض ، لأن هناك بعض الأشخاص لا يعانون من أي مرض نفسي لكن أداؤهم في الحياة أقل مما هو متوقع لأمثالهم ، فحركتهم في الحياة وتكيفهم الاجتماعي وإبداعاتهم أقل مما هو متوقع ، فلا نستطيع أن نقول أن شخصاً ما صحيح نفسياً لمجرد كونه خالي من الأمراض النفسية بالمعنى الإكلينيكي لها ، إذاً فهنالك تعريف أكبر وأشمل وأوسع للصحة النفسية . واختصاراً لجهود كثيرة ، وصل العلماء إلى أن الصحة النفسية هي مفهوم إيجابي متعدد المستويات يكون فيه الإنسان صحيحاً على المستوى الجسدي ثم على المستوى النفسي ثم على المستوى الاجتماعي ، ثم على المستوى الروحي ، إذاً فهو مفهوم متعدد المستويات لابد أن يكون في حالة توازن ما بين إشباع هذه المستويات وتنشيطها ، فلو بالغ أحدهم في إشباع الجانب الجسماني على حساب الجانب النفسي أو على حساب الجانب الروحي ، فبالتالي يكون قد أخل بالتوازن ، ويصبح غير صحيح نفسياً .
قواعد الصحة النفسية للطفل :
وإذا انتقلنا من العام إلى الخاص وحاولنا الإجابة على تساؤل أحد الأمهات ( أو الآباء ) : كيف أتعامل مع ابني لكي يصبح صحيح نفسيا ؟
والإجابة على هذا التساؤل الهام تتمثل في إتباع القواعد التالية :
1- التوازن بين التطور والتكيف :
هناك قاعدة تربوية هامة يمكننا اعتبارها قاعدة ذهبية في هذا المجال ، وهي أن الطفل كائن نامي ، ينمو كل يوم ، ينمو في جسده وفي تفكيره وفي طاقاته وفي إدراكه وفي كل شيء ، فهذا الطفل النامي يتغير من لحظة لأخرى ومن يوم لآخر ، وفي ذات الوقت يحتاج مع هذا التغيير المستمر وهذا النمو المطرد أن يكون في حالة تكيف وانضباط وسلام مع البيئة والمجتمع المحيط به ، وبهذا سنقول أن هذا الطفل لكي يكون صحيح نفسياً ونطمئن عليه ، فلابد أن يكون هناك توازن بين متطلبات نموه وتطوره ومتطلبات تكيفه مع المجتمع والحياة .
ولكي نرى هذا المفهوم بشكل أوضح ، سنفترض أن هناك كفتين ، الأولى كفة التطور والثانية كفة التكيف ، ولكي يكون الطفل صحيح نفسياً ، لابد من حدوث توازن ما بين هاتين الكفتين ، فلو تخيلنا أن كفة التطور زائدة عن كفة التكيف أو أصبحت هي الحائزة على الاهتمام فسيتطور الطفل وينمو بسرعة في جسمه وفي ذكائه وفي تفكيره وفي كل شيء يخصه ، ولكن – وبالمقابل – ليست له علاقة بالمجتمع الذي يعيش فيه ولا يتكيف معه ، فهو في حالة تطور مطلق بدون قيود ، وإذا ترك بهذا الشكل سيصبح أنانياً ولديه حالة نرجسية شديدة ولا يفكر إلا في نفسه ونموه وتطوره ، وفي النهاية سيكون مدمرا لمن حوله ولنفسه أيضاً وفي حالة صراع دائم مع البيئة التي يعيش فيها ، برغم كونه متطورا وناميا ومبدعا .
وعلى العكس ، إذا كان هناك طفل آخر متكيف بدون تطور ، بمعنى أنه مطيع جداً ، هادئ جداً ، ولا يفعل شيء إلا بأمر من الأب أو الأم ، ويحتاج لأمر آخر ليوقف هذا الفعل ، فهو مطيع تماماً لكل ما يأتي إليه من أوامر وتوجيهات وليست له أي حركة تطور أو نمو أو تفكير أو إبداع أو أي شيء . هذا الطفل في معيار الأب والأم وهو صغير طفل مريح جداً لأنه ( بيسمع الكلام ) وهذا هو هدف كل أب وأم , ولكن عندما يكبر سيدرك الأبوين أن هذا الطفل عبء شديد جداً عليهم لأنه لا يمتلك أي مبادرة ولا يمتلك أي ملكات أو قدرات ولا يستطيع عمل أي شيء بمفرده ، شخصية اعتمادية سلبية مملة .
إذاً فلكي تتحقق الصحة النفسية لأطفالنا لابد من مساعدتهم حتى يتطوروا وينموا وفي نفس الوقت نساعدهم على التكيف مع البيئة التي يعيشون فيها ، وهذا التوازن ليس توازناً جامداً أو ساكناً بحيث نزيد هذه الكفة وننقص الأخرى مرة واحدة وتنتهي المهمة ، لكن طالما كانت حركة النمو والتطور سريعة ومتغيرة فلابد من أن يواكبها تغير في حركة التكيف ، فالتوازن هنا توازن ديناميكي بمعنى أنه يتطلب قدر عالي من المرونة ، كلما زادت كفة نزيد الأخرى بمقدار مناسب وهكذا .
2 - الدوائر المتسعة :
صحة الطفل - صحة الأم - صحة الأسرة - صحة المجتمع :
وهذا التوازن ( المذكور أعلاه ) ليس فقط في دائرة الطفل ولكن هناك دوائر أخرى متتالية تحتاج للتوازن فلن ننظر للطفل على أنه كائن وحيد ، لكن سننظر إليه باعتباره دائرة تحوطها دائرة الأم تحوطها دائرة الأسرة تحوطها دائرة المجتمع ، ولهذا يجب أن تكون هناك حالة توازن بين هذه الدوائر فننظر لصحة الطفل وصحة الأم وصحة الأسرة وصحة المجتمع ، فالأم هي الحضن الأقرب للطفل ، فلا نتصور وجود ابن صحيح نفسياً وله أم مضطربة نفسياً ، والأسرة هي الحضن الأكبر الذي يحتضن الطفل والأم معاً ، فلا نتصور كون الطفل والأم صحيحين معاً في حين أن الأسرة مضطربة ، والطفل والأم والأسرة يحتضنهم المجتمع وهو الدائرة الأكبر فلا نتصور أن يبقى هؤلاء في صحة في حين أن المجتمع في حالة اضطراب .
وعندما نقوم كمعالجين بتقييم حالة طفل ننظر لهذه الدوائر ونحدد موضع الخلل , فأحياناً يأتي الطفل باضطراب معين ، وحينما نفحصه نجد أن هناك خلل في أحد هذه الدوائر أو في أكثر من دائرة ، فلابد من التفكير في إصلاح هذا الخلل ، ولا نتوقف عند الطفل فقط ، لأن الطفل هو ممثل هذا الاضطراب ، فالطفل أكثر صدقاً وأكثر براءة وأكثر شفافية ، فيظهر فيه الاضطراب بوضوح لكن لا يكون هو أصل الاضطراب فقد يكون هذا الاضطراب من أم مكتئبة أو مجهدة أو مدمنة أو الأسرة أو المجتمع فننظر إلى أصل هذا الاضطراب . أحياناً نتجه مباشرة لعلاج الأم أ ولعلاج الأسرة ، أو يكون هناك خلل اجتماعي معين ولو تم تصحيح هذا الخلل يكون هذا الطفل في حالة أفضل .
3- الصحة النفسية بين المطلق والنسبي :
وفي الواقع ، مفهوم الصحة النفسية لكل هؤلاء ( الطفل - الأم - الأسرة - المجتمع ) مفهوم نسبي وليس مفهوماً مطلقاً ، بمعنى أنه يختلف من بيئة لأخرى ومن مجتمع لمجتمع ومن أسرة لأسرة وما يمكن اعتباره صحياً في مكان ، يمكن اعتباره اضطراباً في مكان آخر . ولتقريب الفكرة ، سنحكي حكاية صغيرة عن شيخ قبيلة أناني جداً ، هذا الشيخ عرف بطريقة سرية أن البئر الذي تشرب منه القبيلة كلها ، سيسمم في يوم من الأيام ، ونظراً لأنانيته وحبه لنفسه ، أخذ يخزن مياه كافية من هذا البئر في منزله حتى إذا تسمم البئر ، يجد ما يشربه ، فجاء اليوم وتسمم البئر فعلا وأصيب أهل القبيلة كلهم بالجنون ولكنهم لم يموتوا ، فظل هو العاقل الوحيد بينهم ، طبعاً استغرب أهل القبيلة تصرفاته في وسطهم ولم يحتملوه بينهم وفي النهاية قتلوه. فعلى الرغم من أنه العاقل الوحيد بينهم إلا أن اختلافه جعله في أزمة معهم ، وحدث عدم تناسب بين تفكيره وتفكيرهم . إذن فلابد من أخذ هذا العامل في الاعتبار , لأن هناك اضطرابات كثيرة في الأطفال تكون مشكلتها النسبية في الصحة والزمان والمكان ، فلابد من وضع اعتبار للزمان والمكان والظروف عند تقييم هذا الطفل .
سنعطي مثالا آخر بسيط ليوضح هذه النقطة :
لو أن هناك طفل تشتكي أمه من كونه كثير الحركة ويقفز فوق الشبابيك وعلى البلكونات ويكسر الكراسي والأشياء ، وهم يعيشون في شقة غرفتين وصالة ، فهذا الطفل لو تخيلنا أنه انتقل من هذه الشقة الضيقة المحدودة الممتلئة بأشياء زجاجية وقابلة للكسر ، ووضعناه في بيت واسع حوله ساحة كبيرة وشجر ، وعاش الطفل في هذا المكان الجديد يجري في الساحة الخضراء ويقفز فوق الأشجار كما يريد ، وقتها لن تحس الأم أي شقاوة منه أو أي حركة زائدة ، وفي نهاية اليوم يعود بعد هذا الجهد المضني لينام والأم راضية وهو راض ، هنا اعتبار المكان والظروف مهم جداً .
4 - الإستقطاب بين النقيضين مقابل الحوار والتعايش :
هناك أسر تكون في حالة استقطاب ما بين نقيضين ، بمعنى أنها أسرة أحادية النظرة وأحادية التفكير ، فلا ترى الأشياء إلا بلونين ، أبيض أو أسود ، ولا تستطيع رؤية درجات الألوان البينية ما بين الأبيض والأسود ، يرون أن ما يفعلوه هو الصحيح المطلق وكل ما عداه خطأ ولا يقبل النظر ولا التفكير ولا الحوار ، فينشأ الطفل في هذا الجو وهو مستقطب استقطابا شديدا في ناحية واحدة أو اتجاه واحد ، أحادي التفكير ، لا يستطيع رؤية سوى احتمال واحد في كل شيء ولون واحد من كل الألوان . من هنا عندما يكون الاستقطاب في اتجاه ، لابد أن يتصارع مع الاتجاه الآخر أو يضاده ، ويفقد هذا الطفل القدرة على التحاور والتعايش مع الآخرين المختلفين عنه ، وبهذا الشكل يصبح الطفل دائماً في صراع مع أصحابه ، ومع الجيران ، ومع المجتمع ، وعندما يكبر ، يظهر موضوع الاستقطاب وأحادية التفكير مع الأب والأم ، لأنه تعود أن الحقيقة واحدة فقط ، الدنيا بها لون واحد ، عندما يكبر ويدخل فترة المراهقة ، يختلف عن الأب والأم ، لا يحتمل هذا الاختلاف فيبدأ بالعدوان على الأب والأم ، لأنهم لم يعودوه الاختلاف مع الآخرين ، والتحاور والتعايش معهم ، فيدفع الأب والأم ثمن هذا الاستقطاب الذي أعطوه للطفل من خلال الجو الأسري القائم على فكرة الاستقطاب أو أحادية التفكير .
5- الإحتياجات بين الإشباع والحرمان :
للإنسان عدد كبير من الاحتياجات ، وهناك عالم نفس شهير هو أبراهام ماسلو ، قام بعمل ما يسمى " هرم الاحتياجات " ، فقال إن الإنسان له احتياجات جسمانية بيولوجية عبارة عن الأكل والشرب والمسكن والملبس ، هذه الاحتياجات لابد أن تشبع أولاً ، وتمثل قاعدة الهرم ، يليها احتياج للأمن والاستقرار ، يليه احتياج للانتماء ، الانتماء لأسرة ولبلد وللإنسانية ، يليه احتياج للحب ، أن يكون الإنسان قادراً على أن يحب ويحب ، يليه احتياج للتقدير ، أن يحس بأن الناس يقدرونه كشخص ، ويقدرون ما يفعله ، وسعيدون به ، وانتهى ماسلو في آخر الهرم بالاحتياج لتحقيق الذات ، أن يحقق الإنسان ذاته في هذه الحياة ، وتوقف عند هذه النقطة ، لأنه كان يتبع المدرسة الإنسانية ، التي كانت تنظر للإنسان على أنه هو نهاية المطاف , لكننا نضيف إلى هذه الاحتياجات احتياج مهم جداً هو التواصل الروحي ، فالإنسان لديه احتياج للتواصل الروحي مع الله ، مع الكون ، مع السماء ، مع الغيب ، وهذا الاحتياج يمكن فهمه بشكل عملي وعلمي موضوعي من المعابد المنتشرة في كل أنحاء العالم تمثل مراحل التاريخ المختلفة ، وكيف أن الإنسان كان محتاجا لأن يكون على علاقة بالسماء وبالله سبحانه وتعالى , فأنشئت المعابد في كل الحضارات لتمثل هذا الاحتياج الحيوي المهم عند الإنسان .
و هذه الاحتياجات لابد من أن تشبع بتوازن ، بمعنى أن نبدأ أولاً بالاحتياجات الأساسية ، الأكل والشرب والمسكن والملبس ، ثم الأمان ، والانتماء ، ثم الحب ، وهكذا .. كل حاجة من هذه الحاجات تشبع وتأخذ حقها ، ولا تطغى إحداها على الأخرى ، ومع هذا هناك قاعدة مهمة وهي أن إشباع الاحتياجات لدرجة التخمة يؤدي إلى حالة من الترهل والضعف والمرض ، فلابد من وجود توازن بين درجة الإشباع ودرجة الحرمان ، فالإنسان محتاج أن يشبع وفي نفس الوقت أن يحرم من بعض الحاجات .. لماذا؟ لأن الحرمان ينشط الدوافع ، ويجعل الإنسان يتحرك ويعمل ويكون عنده أمل ، ويسعى وراء هدف .....
لو أشبعت كل حاجة ، فسيتوقف الإنسان عن السعي والحركة والتفكير والإبداع ..... إذن لابد من وجود أشياء يحتاجها .. أشياء يحرم منها ويسعى إليها ويحلم بها .. إذن فهناك توازن ما بين الإشباع والحرمان ، فالطفل لو أخذ كل احتياجاته فلن يكون صحيحا ، ولو حرم حرماناً شديداً ، ستصبح عنده مشاعر حقد وكراهية وحرمان وكره لمن حوله ، لأن كل الذي يحتاجه لا يجده . وقد وضع علماء النفس معادلة يمكن تجربتها ، وهي في الحقيقة مفيدة ، قالوا أنه يكفى تلبية 70% من احتياجات الطفل ، بمعني : لو الطفل طلب مائة حاجة ، يلبى له منها 70 فقط ، حتى لو كان ال 100 حاجة منطقيين وهو يحتاجهم فعلاً ، لكن تلبية ال 100 حاجة لن تؤدي إلى سلامة هذا الطفل ، فلابد من وجود شيء ينقصه .. يسعى إليه ويحلم به ، ويكون عنده الأمل أن يحصل عليها في وقت من الأوقات ، ونشجعه أن يعمل ويسعى للحصول عليه .
6 - مواكبة مراحل النمو :
غالباً ما تأتي الأم وتقول أن أولادها عندما كانوا صغاراً كانت تحبهم وتحس بأنهم جزء منها ، وكانوا منسجمين جداً معها ، لكن عندما كبروا ، أصبحت تحس بغربة معهم ، كأنهم لم يعودوا أولادها ، ولم تعد منسجمة معهم كما كانت ، فهي عاجزة عن فهمهم ، وهم بالمثل غير قادرين على فهمها ، لا تعرف بالضبط من المخطئ هي أم هم ..... هذه الأم نقول لها أنها كانت متفقة مع أولادها في مرحلة معينة وهم أطفال ، لكن أولادها يكبرون ويتطورون في تفكيرهم وفي عاداتهم وفي تقاليدهم وفي تطلعاتهم , لكن للأسف هي لم تتمكن من مواكبة هذه المراحل ، وقفت عند مرحلة معينة وثبتت عندها فى حين أن أولادها مستمرين في النمو والتطور ، فهنا نشأت فجوة ما بين الاثنين ، فتكون الغربة واختلاف اللغة ، فهي لا تفهم دنياهم ولا حياتهم ولا طبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه ، وطريقة التعامل بينهم .....
وهكذا نقول لها أنها هي والأب لابد وأن يواكبوا مراحل النمو ، بمعنى أن يعيشوا معهم مرحلة مرحلة . وهذه المواكبة مفيدة ليس فقط للأبناء ، بل للأب والأم لأنهما أيضاً محتاجين لأن يعيدوا هذه المراحل مرة أخرى لأنفسهم ، فمثلاً هناك أب لم يعش مرحلة طفولته جيداً ، ولم يعش مرحلة مراهقته جيداً ، لأي سبب من الأسباب ، فيعيد التجربة مرة أخرى مع أولاده في هذه المرحلة ، وكأنه يعيش المرحلة التي فقدها أو التي أفلتت منه بدون ذنب منه ، أو لأي ظروف حدثت ، هذا يفيد نفسياً ، لأن الأشياء التي لم يتمكن من فعلها ، سيعود لمعايشتها مرة أخرى ، فيكمل النقص أو الأماكن التي كانت مؤلمة نتيجة للحرمان في مرحلة معينة ، وفي نفس الوقت سيكون على نفس الموجة مع أبنائه ، فتعطي فائدة مزدوجة للطرفين ، وتجدد دائماً طفولة ومراهقة وشباب الأب والأم وتقوم بعمل حالة من التكامل في شخصيتهما .
7 - احترام إرادة الطفل :
كثير من الآباء والأمهات يظنون أن الطفل ليست له إرادة أو أنها تنمو عندما يكبر ويصبح شاباً أو رجلاً ، لكن الطفل له إرادة من وقت مبكر جداً ( ويمكن أن تلاحظ الأم هذا من خلال رفضه لأشياء وتمسكه بأشياء ) وليس مسلوب الإرادة ويتحرك بريموت كونترول كما يريد الأب والأم ، وحتى وهما معترفين بوجود هذه الإرادة ، يريدون أن يلغوها ، لأنهما يعتقدان أن عندهم خبرة وعندهم معرفة بالحياة أكثر من هذا الطفل فلابد من أن يختاروا له طريقته في التفكير وفي الحياة وفي تحديد الأهداف والأساليب وكل شيء ، وكثير من الآباء والأمهات يصلون إلى درجة أن يحاولوا جعل هذا الطفل صورة طبق الأصل منهم ، وهم يعتقدون - واهمين - أنهم أفضل صورة إنسانية ممكنة أو أفضل نموذج ممكن ، وعندما يواجه الطفل بمحاولة إلغاء إرادته يبدأ في هذه اللحظة في إتباع سلوك العناد ، وهذه مشكلة كثير من الآباء والأمهات يشكون منها ويقولون أن ابنهم عنيدا ، ويحاولون علاجه من هذا المرض ، العناد ! ، ويحضرون هذا الابن لكي يقوم الطبيب النفسي أو المعالج بترويضه لكي يسمع الكلام ويقوم بتنفيذ كل ما يريدونه ، طبعاً هذا غير ممكن عملياً , وإرادة الله أعطت لهذا الطفل هذه الملكة ...... أن تكون له إرادة مستقلة ، خلقه الله صاحب إرادة ، فلماذا نحاول أن نغير خلق الله ،
وهذا لا يعني أن نتركه تماماً ليفعل كل ما يشاء بناءاً على كونه لديه إرادة مستقلة . وقد قام العلماء بتقسيم الهداية ، وهي نوع من التربية والتوجيه ، فقالوا إن الهداية نوعان : النوع الأول " هداية إبلاغ " ، والثاني " هداية فعل " . هداية الإبلاغ هذه أن نقول للطفل هذا صواب وهذا خطأ ، لابد لكي يكون عنده قانون يتكيف به مع الحياة والبيئة ومع الكون كله ، فلابد أن يبلغ الأب والأم هذا القانون للطفل ، ولكن لا يتوقعوا الامتثال التام لهذا القانون بمجرد إبلاغه ، لأن هناك هداية أخرى هي هداية الفعل ، أن يستجيب الطفل للرسالة التي وصلته لا يعني بالضرورة أن يستجيب لها كلها ، يستجيب لأشياء ويؤدي أشياء ويغير أشياء ويعدل أشياء ، لأن الله خلق له إرادة ورؤية , وله فكر حتى وهو صغير ، لابد أن نتأكد من هذا تماماً ، فسيبدأ في الاختيار ، وسيبدأ بالتجريب . الأب والأم وصلوا لما هما فيه حالياً بعد مراحل كثيرة من التجارب والأخطاء والنضج والتعلم ، ويريدون أن يأخذ الطفل أو الطفلة نفس النمط الذي وصلوا إليه في هذه المرحلة من العمر ، مثلاًَ هما في الأربعين أو الخمسين ، يريدون أن يكون لطفل أو طفلة في عمر خمس سنوات أو عشر سنوات نفس آرائهم وتوجهاتهم ، وهذا ضد الفطرة ، وضد طبيعة الإنسان ، وضد إرادته واختياره ومسئوليته التي خلقه الله عليها ، ولو أصر الأب والأم على هذا تحدث المشكلة التي نراها دائماً ويشتكي منها الكثير من الآباء والأمهات ، أن الطفل عنيد أو الطفلة عنيدة ، لا يسمعون الكلام ، لا يريدون تنفيذ سوى ما يرونه ، الحقيقة أن ما خلق هذا الموقف المعاند ، هو أن الأب والأم دخلوا في شرنقة الماضي ، ولم يتمكنوا من رؤية احتياجات الطفل وضروراته ومجتمعه وظروفه والدنيا التي يعيش فيها ، فهو يعيش في دنيا مختلفة كثيراً عن دنياهم ، وبما أن لديهم سلطة على هذا الطفل فإنهم يحاولون التحكم فيه ، وجعله يمشي على شريط القطار الذي حددوه له ، النتيجة ستكون شيئاً من اثنين ،
إما أن يستسلم الطفل تحت هذا الضغط والقهر من الأبوين ، فيكون طفلا سلبيا واعتماديا ليس له إرادة ولا اختيار ولا مبادرة ولا تلقائية ولا أي شيء على الإطلاق ، هو أسلم كل شيء للأب والأم ، وفي نفس الوقت يقوم بعمل شيء يسمى العدوان السلبي ، ( مش انتوا تريدوني هكذا ؟. شوفوا إيه الذي سيحصل ) ، من الممكن أن يفشل دراسياً ، أو اجتماعياً ، أو أخلاقياً ، هو قد سلم نفسه ، ويريد أن يحمل نتيجة هذا الفشل للأب والأم اللذان أصرا على التحكم في خط سيره وعلى جعله صورة طبق الأصل من الذي يريدونه ومن الممكن أن يتمرد الطفل ، أن يرفض عمل أي شيء ، ويصبح عدوانيا ، يفعل ضد كل ما يقولونه له ، ويصبح عنيفا جداً ، ( تريدني أذاكر ، لا مش هذاكر ، تريدني أنجح ، لا مش هنجح ، تريدني أبقى أخلاقي كويسة ، لأ همشي مع أسوأ ناس واعمل كل اللي انتوا بتكرهوه ) ، لأن هناك صراع إرادات ، إما أن أكسب أنا أو أنتم ، وطالما لدي شيء أستطيع عمله ، فسأقوم به ، وسنرى في النهاية من سيكسب ..
وتكون رحلة صراع مؤلمة وضارة للطرفين ويتراكم فيها ، مشاعر سلبية عند الطفل تجاه الأبوين ، وعند الأبوين تجاه الطفل ، ويدخل الجميع في أزمة ، لا يستطيعون الخروج منها ، إلا لو دخل طرف ثالث ، يفك هذا الاشتباك ، ويبدأ في إخراج هذه المشاعر السلبية التي تراكمت ومشاعر الصراع والعداء التي تكونت نتيجة لإصرار كل طرف على إلغاء إرادة الطرف الآخر . وهناك أمثلة عظيمة جداً من سلوك بعض الأنبياء في هذه المسألة لأن بعض الناس يظنون أحياناً أن واجبهم الديني أن يحموا أولادهم من الخطأ , وهذا صحيح ، قال تعالى :
" يأيها الذين آمنوا ، قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة "
، لابد من توعية الابن للشيء الذي يمكن أن يؤدي لهلاكه في الدنيا وفي الآخرة ،وهذه وظيفة الأب بسبب خوفه على الابن ، ولأنه أغلى شيء بالنسبة له , ووظيفة الأم أيضا . لكن سنقول أن ما علينا هو هداية التبليغ ، لكن هداية الفعل نترك أمرها لله سبحانه وتعالى ، وندعوا أن يوفق الله الابن لها ، لأننا لا نملكها . فأنت أيها المربى تقوم بعمل ما عليك لكن في النهاية ستحترم إرادة الابن أو البنت واختياره ، حتى لو كان هذا ضد اختيارك أو عكسه ، الكثير من الناس لن يحتمل هذه الفكرة وسيدخلون في صراع مع الأبناء ،
سنعطي مثلاً لاثنين من الأنبياء الكرام الأول :
نوح عليه السلام ، وابنه ، نوح جهز السفينة ، ويعرف بمجيء الطوفان ، فنادى لابنه ، ولم يكن ابنه على نفس الطريق ، فقال :
" يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين "
، وهذه كانت إرادة نوح عليه السلام ، ورؤيته ، بناءاً على خبرته ومعرفته والوحي الذي ينزل عليه ، وهو نبي ، ويخاف على ابنه ، لكن تظهر إرادة الابن ورؤيته واختياره :
" سآوي إلى جبل يعصمني من الماء "
، فرد الأب :
" لا عاصم اليوم من أمر الله "
، اليوم مختلف عن كل الأيام السابقة ، هذا خطر مختلف تماماً ، ربما كان من الممكن السماح في الاختيار قديماً ، لكن اختيار اليوم مهلك في الدنيا وفي الآخرة ، ستموت على الكفر ، ومع صعوبة الموقف ، نوح يرى ابنه سيموت بعد لحظات على الكفر ، يصر الابن على أن يأخذ هذا الموقف الرافض لموقف الأب ، وكان متوقعا أن سيدنا نوح لو كان يفكر مثلنا ، أن يرسل له أتباعه ليحضروه إلى السفينة بالقوة ، لكن هذا لم يحدث ، سيدنا نوح أدى البلاغ ، وهو يعرف أن هداية الفعل بيد الله سبحانه وتعالى ، ونجا الأب بما رأى وهلك الابن بما رأى وفعل , لكن الله خلق الإنسان بهذه الإرادة ولحكمته أراد لها أن تعمل ، وكان هذا مثلاً في العصيان ، سنأخذ مثلاً آخر في الطاعة ، ونرى أنه أيضاً في حالة الطاعة لا تلغى الإرادة عند الطفل أو عند الابن . سيدنا إبراهيم ، عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل ، وهو يعرف أن رؤيا الأنبياء حق ، وأنها واجبة التنفيذ ، المتوقع - حسب ما نفهم - أن أمر الله لابد من أن ينفذ ، ويذبحه فوراً ، لكن سيدنا إبراهيم لم يفعل هذا احتراماً لإرادة ابنه إسماعيل فذهب إليه بمنتهى المودة والرحمة والعطف :
" يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى "
، نرى كيف قال له سيدنا إبراهيم : " يا بني " ، و" إني أرى في المنام " ،لأنه لو كان قال له إن الأمر من الله مباشرة ، لما كان من الممكن أن يختار ، لكنه أعطى فرصة لإسماعيل ليقول رأيه ، مثلاً ، هذا منام ويمكن تأجيله أو التفكير فيه ، فانظر ماذا ترى ؟ ، مع أن سيدنا إبراهيم يعرف أنه لا رأي هنالك ، هذا أمر إلهي ، يقول سيدنا إسماعيل عليه السلام :
" يا أبتي افعل ما تؤمر ، ستجدني إن شاء الله من الصابرين "
، هنا اختار وكان له فضل الاختيار يثاب عليه ، ولم يذبحه مباشرة بدون اختيار ، حتى لا يكون قد ذبح غدراً ، دون إرادة ، ولكن ترك له فضل الاختيار . وهذا درس يعلمنا أن الطفل له إرادة وأننا كآباء وأمهات ليست وظيفتنا أن تلغي هذه الإرادة عند الطفل ، ولكن أن نوجه و نهذب ، أن نقول ونبلغ ونوضح ونبين ، لكن في النهاية ، سنسلم ، لأن هذا الطفل له إرادة وأن الله شاء بحكمته أن تكون هذه الإرادة موجودة ، وتأتي آية مهمة تحسم هذا الموضوع تقول :
" ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس أن يكونوا مؤمنين "
، فاحترام إرادة الإنسان حتى في الإيمان والكفر " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " ، لا يوجد إكراه حتى في الأشياء شديدة الأهمية ، إذن فمن باب أولى أن ألأشياء الأقل أهمية لا يوجد فيها إكراه . ولكي يؤكد لنا ربنا هذه الحقيقة ضرب أمثلة لاستحالة إكراه البشر على شيء وكانت الأمثلة تمثل غالبية العلاقات بين البشر , فهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية عمه أبو طالب رغم كل ما بذله معه من جهد , ولذلك قال له الله تعالى : { إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء } , وسيدنا إبراهيم لم يقدر على هداية أبيه , وسيدنا لوط لم يقدر على هداية زوجته , وسيدنا نوح لم يقدر على هداية ابنه .......
وهكذا تتعدد النماذج في علاقات مختلفة لتثبت في النهاية أن هداية الفعل لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى , لذلك حين يفعل الأب ما عليه أو تفعل الأم ما عليها فلا يبقى إلا أن يدعوا لابنهما بالهداية والتوفيق , ولا يحاولان قهره أو إلغاء إرادته . وهذه النقطة تسبب صراعاً شديداً ما بين الآباء والأمهات من ناحية والأبناء من ناحية أخرى ، وتداعياتها السلوكية كثيرة جداً ، إما سلبية واستسلام و شخصية اعتمادية وإما عناد وتمرد ومكايدة وصراع ومشاكل ليس لها أول من آخر .
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
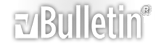


 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس